أدب المغارب.. كرونولوجيا تاريخية
إن أدب المغارب الذي نقاربه هنا هو تحديداً الأدب الفرانكوفوني، المكتوب من طرف بعض أدباء دول المغرب الثلاث بالمعنى الحصري في العهد الاستعماري. وقد فتح مؤسسو هذا التقليد الأدبي الفرانكوفوني أفق التأمل والتمثـُّـل واسعاً في مشكلات وتحولات مجتمعاتهم مع حساسية عالية لأسئلة الذات والهوية، خاصة في ظل وجود الآخر الغربي الجاثم على صدر المجتمع والثقافة المحلية في أيام الاستعمار. وقد تجسد هذا الهمّ الذاتي والماهوي الجامع خاصة مع كتاب الجيل الثاني زمنياً -الأول إبداعياً- الذين دخل إنتاجهم مرحلة الذروة في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، ومن هؤلاء كتاب مثل إدريس شرايبي وأحمد الصفريوي، ومولود فرعون ومولود معمري، ومحمد ديب، وكاتب ياسين، وغيرهم كثر ممن سنفصّل الحديث في منتجهم الأدبي في مواضع تالية من هذه القراءة التجميعية للمدونة الأدبية المغاربية المكتوبة باللغة الفرنسية.
وقد واصل جيل السبعينات طرح ذات الأسئلة التي طرحها الجيل المؤسس، وثابر على ذات المقاربات نفسها، وإن كانت نبرة الطرح في كتابات هذه المرحلة بدت أكثر عنفاً بشكل ملحوظ، على المستوى الخطابي على الأقل. وضمن هذا الجيل الثاني، أو الموجة الثانية من الأدباء المغاربيين المفرنسين، يمكننا تصنيف كل من: رشيد بوجدرة، وَعَبَد الكبير الخطيبي، ونبيل فارس، ومحمد خير الدين، وَعَبَد اللطيف اللعبي، وطاهر بن جلون، وكلهم ولدوا في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين.
وكان الجيل الثالث ضمن حركة الأدب المغاربي الناطق بالفرنسية أكثر التزاماً وقدرة على الاشتباك مع الحقائق والوقائع السياسية والاجتماعية الداهمة. وقد واجهته تحدياتُ لخطةٍ سوسيو- تاريخية مختلفة، بحكم تعقيد البنيات الاجتماعية والسياسية المختلطة- المتجلطة في واقع جديد بدأت الدولة الوطنية تواجه فيه أسئلة المسار والمسير! هذا فضلاً عن تعقيد آخر محايِث أيضاً هو التباس العلاقة مع الآخر الغربي، وتحديداً الفرنسي القابع هناك على الجانب الآخر من البحر المتوسط، والجاثم هنا بلغته ومنظومته الذهنية والعقلية في كل الثنايا والطوايا، بل في شغاف الحنايا.
وقد تميز كُتاب هذا الجيل الثالث بطرْقهم لموضوعات استظهار من قبيل الوعي بالذات الفردية ومحلها من الإعراب في السياق المجتمعي العام، وهذا إشكال يكتسي أهمية خاصة في مجتمعات مغاربية -وعربية- تتآكل في سياق حراك البنيات والعلاقات والمؤسسات الاجتماعية فيها مساحة الخيار الفردي الذي ينسحق وينمحق ويخفت صوته وينضغط إلى منطقة الظل نتيجة قوة الذات الجمعية الساحقة. ولذلك نجد هذه الذات الفردية، أو حتى النزعة الفردانية، معبّرة عن نفسها في أحيان كثيرة من خلال أبطال وشخوص السرديات المغاربية الكبرى في هذه المرحلة، حيث ترتفع عقيرة المطالبة بالاعتراف بالذات الفردية، في إنسانيتها وخصوصيتها، ليُتعامل مع الإنسان باعتباره ذاتاً لها حرية المسار والخيار، بدلاً من اختزاله فيما يشبه السن الدائرة جبْراً وقسراً -وقهراً- ضمن عجلة تاريخ ومجتمع كبيرين، مفارقين لتطلعاتها في كثير من الأحيان! وقد كانت مرحلة التحول من الكائن إلى الشخص -إن صحت هنا استعارة تعبير المفكر المغربي محمد عزيز الحبابي- هذه متزامنة مع ظهور نزوع عام -وربما عارم- نحو الوعي بقيمة الذات الفردية على صعيد إنساني أوسع، وبدايات ظهور منظمات المجتمع المدني كفاعل جديد من غير الدول، يتحرك في الفضاء العمومي. وكان من أبرز رموز هذا الجيل الثالث من الكتاب المغاربيين ذوي الإنتاجات الناطقة بالفرنسية رشيد ميموني، وَعَبَدالوهاب المؤدب، وفؤاد العروي، والطاهر جاعوط، ومحمد مولسهول «ياسمينا خضرا».
أما الجيل الرابع فيمكن إدراج حتى بعض كتاب اليوم في خانته، وهو جيل عقد التسعينيات وبداية القرن الحادي والعشرين، ويمكن اعتبار رواية «طلع النهار» لإدريس جعيدان، بداية فارقة لهذا الجيل الجديد. وتتسم هذه المرحلة بشكل خاص بدخول أصوات وأقلام قوية من الكتاب الذين ولدوا أو نشأوا في فرنسا وبلاد المهجر الغربي بصفة عامة، والذين كانت معرفتهم بأرض الآباء والأجداد بشمال أفريقيا محدودة، بل هي في الغالب معرفة نقلية أو إسمية لا غير. وقد سجل هؤلاء الكتاب الذين ولدوا أو نشأوا منذ أيام طفولتهم الأولى في فرنسا، صوراً مختلفة من أنواع التفاعل مع المجتمع المستضيف، وشغلت اهتمامهم قضايا وإشكالات من نوع جديد، متصلة في عمومها بهموم الهجرة، والإسلاموفوبيا، ومشكلات الاندماج، و«الإسلام الفرنسي».. والآن تفشي شعبويات الفاشية والكراهية، وتحديات اليمين المتطرف في عموم أوروبا، وعدميات العنف والإرهاب، سواء بسواء.
على أننا سنركز في هذه القراءة التجميعية الاستطلاعية، لدواعٍ إجرائية وموضوعية، على الأدب المكتوب قبل سنة بداية الألفية الجديدة، وذلك لأسباب ليس أقلها ضرورة تخصيص قراءة موسعة أخرى لأدب فترة العقد ونصف العقد الماضية، وأيضاً لدخول عالم النشر الإلكتروني على خط الإنتاجية الأدبية المغاربية بالفرنسية منذ ذلك التاريخ. وكذلك لسبب موضوعي آخر متصل بعدم الرغبة في ربط بعض ما سيأتي في هذا الملف، خاصة في قصاصاتة النهائية وبعض مآلات نقده الثقافي، بأي كاتب معين باسمه أو رسمه ممن ينشطون الآن في الثقافة والإعلام، ولعل فترة الـ16سنة الأخيرة تكون مسافة أمان كافية لذلك. وأيضاً لأن النشر الأدبي في العالم الافتراضي -كما لاحظ بذكاء المفكر الإيطالي الراحل امبرتو إيكو- يغلب عليه الارتجال والاستسهال، حيث أطلقت الإنترنت -ضمن مُخرجات قمقمها العجيب- جيوشاً من الحمقى وحاطبي الليل الذين ينشرون كل ما هب ودب من مُرسَل الكلام المفتقد للشرط الأدبي الإبداعي، بتعبير إيكو طبعاً. هذا حتى لا نقول إن كثيراً من «أدباء النت» وكتَبَة موجة الألفية الجديدة، يسهل أن تسقط عنهم صفة الكتابة أصلاً، بل قد يبدو بعضهم أحياناً، «إذا كتب»، كأكول الجاحظ، قال: كان إذا أكل سَكَرَ وسَدَرَ وانبهر، وعصبَ وعصفَ، ولم يسمع ولم يبصر!
على أننا سنخص كل واحد من البلدان المغاربية الثلاثة بعمود تجميعي لإبراز بعض ملامح أدبه النسوي، في الفترة المستهدفة، على أمل سد طرف بسيط من أي نقص ممكن في حجم تلقي الإبداع النسوي، على اعتبار اتساع معرفة القارئ الكريم بما كتبه مشاهير الأدباء الرجال، ويُسر الاطلاع عليه في المكتبات والترجمات والإنترنت أيضاً. وقد كان للمبدعات المغاربيات فعلاً حضور أدبي قوي يستحق التسجيل والاحتفاء. وتعتبر طاووس عمروش وآسيا جبار وفاطمة المرنيسي وهالة باجي ضمن رائدات الأدب النسوي المغاربي الفرانكوفوني، كما ساهمت في هذا التيار أيضاً كاتبات أخريات أقل شهرة سجلن بمرارة وحرارة معاناة وتطلعات وآلام وأحلام المرأة المغاربية -والعربية- عبر شخوص سردياتهن، وما تكابده هذه الشخوص من فصام نكد وتمزقِ ذاتٍ وشقاء وعيٍ بين الذات الفردية ككيان حر في الخيار والقرار، وبين أعباء ضغط المجتمع ذي النزوع التاريخي الراسخ لسحق أي تغريد نسوي خارج السرب، وتهميش وتهشيم الذوات الفردية عموماً كائنة ما كانت، بغض النظر عن الخلفية الجنوسية «الجندرية»، الرجالية أو النسوية، لا فرق.
أسبقية جزائرية.. لأسباب تاريخية
ويمكن اعتبار الجزائر هي البلد الذي ظهرت فيه أولى الكتابات المغاربية الناطقة بالفرنسية وذلك بحكم أسبقية الاستعمار الفرنسي زمنياً في الجزائر الذي بدأ في سنة 1830 من جهة، وأيضاً لطابعه الإحلالي الاستيطاني من جهة أخرى. هذا في حين لم تمتد «الحماية الفرنسية» -وهي التسمية شبه الرسمية يومها للاستعمار- إلى تونس إلا بعد احتلال الجزائر بأكثر من نصف قرن، بعد اتفاقية باردو سنة 1881، ثم اتفاق المرسى سنة 1883، وإلى المغرب بأكثر من ثمانين سنة في 1912. وقد استقلت تونس والمغرب أيضاً سنة 1956 قبل استقلال الجزائر في 1962.
ومن ثمّ فقد كانت فترة الوجود الاستعماري الفرنسي في تونس والمغرب، قصيرة نسبياً إن قورنت مع الـ132 سنة من الاحتلال الاستيطاني في الجزائر، التي شهدت عملية توطين إحلالي واسعة من قبل المستوطنين البيض (المعمِّرين، كما كانوا يُسمَّوْن حينها)، القادمين من الأرياف وهوامش النسيج الحضري الفقير في مختلف المدن الفرنسية والأوروبية.
ولذلك ففي سياق المحايثة الجيلية لا نجد في المغرب وتونس أي كتاب ذوي شأن مجايلين للموجات الأولى من الكتاب الجزائريين المفرنسين. كما أن قوة المقاومة الثقافية في البلدين بحكم وجود الزيتونة في تونس والقرويين في المغرب كانت أيضاً أكثر رسوخاً بما لا يقاس، وإن كان هذا لا يعني أيضاً أن المقاومة الثقافية في الجزائر لم تكن قوية، ويكفي هنا استحضار جهود «جمعية العلماء المسلمين»، بقيادة الشيخين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي. ولكن غياب الإطار المؤسسي التاريخي، وشدة القبضة الاستعمارية، ربما أثرا بشكل أكبر على موازين قوى المعركة في الجزائر على جبهة المقاومة الثقافية. وكانت النتيجة بعد الاستقلال أن مستوى نجاح التعريب كانت أقوى بكثير في تونس والمغرب منه في الشقيقة الواقعة بينهما.
ولذلك فقد كرست بدايات الأدب الفرانكوفوني المغاربي أسبقية جزائرية، دون شك، ولكن تزامناً مع أواخر الجيل الثاني من الكُتاب في الجزائر -من المتوطّنين الأوروبيين واليهود أولاً، ثم فيما بعد من بعض الجزائريين- بدأت الكتابة الأدبية بلسان فولتير وموليير تظهر في تونس مع كتاب مثل «ألبير ميمي»، (+1920)، (وهو من أب ذي أصول إيطالية وأم أمازيغية يهودية)، حين نشر روايته السيَرية- الذاتية «تمثال الملح»، كما أصّل أيضاً لرؤاه الأدبية للذات والهوية في مقاله «صورة مستعمَر». وفِي ذات الفترة الزمنية نفسها ظهرت في المغرب أيضاً رواية أحمد الصفريوي «مسبحة الكهرمان»، سنة 1949. ولكن الكتابة السردية في المغرب عرفت، لأول مرة، طفرة أدبية نوعية مع إدريس شرايبي (1926-2007).
أوجاع اليوم وأشواق الغد
إن كل هؤلاء الكُتاب الرواد الذين ينظر إلى كثير منهم اليوم نظرة مناقبية تبجيلية وتعتبر أعمالهم من كلاسيكيات الأدب المغاربي الناطق بالفرنسية، شغلت اهتمامهم قضيتان، أكثر من أي شيء آخر، الأولى، قضية تأكيد معاناة الذات الاجتماعية المغاربية في الواقع الراهن، وعرض ملامح وملاحم وآلام وآمال الشعوب المغاربية المستعمَرة. والقضية الثانية، المترتبة استطراداً على الأولى، هي التبشير بواقع آخر بديل بعد اجتراح التجاوز الممكن اللازم على طريق التغيير، واقعٍ إنساني عنوانه المساواة والتعاون والتضامن والتساكن والتعارف البنّاء بين الناس بغض النظر عن أصولهم العرقية والثقافية، وهذا الواقع هو ما يتعين أن يعيه المستعمَر (بالفتح، ولاحظ حتى تواطؤ الدلالة الليبيدية في لفظة «الفتح» نفسها)، بقدرما يلزم التعايش مع حقيقته الحتمية والتكيف مع استحقاقاته المقبلة أيضاً المستعمِر (بالكسر، ولاحظ أيضاً تواطؤ الدلالة القهرية المتضمنة في معاني «الكسر»).
وقد حرص هؤلاء بشكل خاص على الحديث إلى المستعمِر بلغته ومنظومته الذهنية والقيمية وثيماته الأسطورية وأمثولاته التاريخية. وحتى من اختاروا، أحياناً، الامتياح في بعض أعمالهم من التراث التقليدي المغاربي، واستدعاء إحالات تاريخية أو قيمية منه، ظل هاجس تأكيد الذات وإبرازها في وجه تمركز الآخر حول ذاته همّاً شاغلاً وشوقاً وتوْقاً مؤسساً في معظم نصوصهم الإبداعية، حيث نحوْا إلى إبراز الوجه الآخر الأصيل للمجتمع المحلي بمعزل عن تأثيرات الهيمنة الخارجية، وهذا نجده بوضوح في بعض إنتاجيات هؤلاء في الجزائر خاصة مع سعد الدين بن شنب (1907-1968)، وكذلك مصطفى الأشرف (+1917)، ومولود فرعون، ومولود معمري، وفِي المغرب نجد هذا الملمح عند أحمد صفريوي، وأليزا شيمانتي (وهي كاتبة من الأقلية اليهودية المغربية)، وكذلك في تونس عند محمود أصلان، وغيرهم كثير.
عمرٌ آخر للفرنسية
ومع بداية عهد الاستقلالات وبزوغ نجم الدولة الوطنية، وخاصة بعد استقلال الجزائر في 1962، ظن كثيرون أن الكتابة الأدبية باللغة الفرنسية ستنحسِر، إلا أنها، للمفارقة، استمرت بل راجت أكثر من ذي قبل ليس فقط في الجزائر، التي رفعت خلال العقدين التاليين يافطة التعريب، وإنما أيضاً في المغرب وتونس، اللتين ظل حضور المنتج الثقافي الفرانكوفوني فيهما أقل منها طيلة الفترة الكولونيالية. وفِي الجزائر أفقد الانتصار والاستقلال أدب الثورة كثيراً من الوهج والشاعرية الملحمية. وقد شهدت سنوات ما بعد الاستقلال خاصة إنتاجاً شعرياً غزيراً بلسان فولتير، على أرض الجزائر المستقلة نفسها، ويمكن الإشارة هنا إلى أعمال جان سناك (1926-1973) وهو شاعر من أصل أوروبي (إسباني) آثر التوطُّن في الجزائر بعد الاستقلال، وظلت أشعاره ملهمة لجيلين متتابعين من شعراء الجزائر المفرنسين، وخاصة منها «شمس تحت الدموع»، و«صباحات شعبي»، و«قبل- الجسد». وقد ظلت نصوص هذا الشاعر هي الأكثر شهرة في الجزائر ما بعد الاستقلال، حتى مقتله -على يد لص في جريمة حق عام عادية- في أغسطس 1973. وقد تأثر به شعراء جزائريون كثر في هذه المرحلة مثل جمال عمراني، وشعراء لاحقون مثل يوسف سبتي (+1943 اغتيل في 1993)، وكذلك رشيد بوجدرة، وحميد تيبوشي، وَعَبَد الحميد الأغواطي، والطاهر جاعوط (+1954 اغتيل في 1993)، وآخرون كثر. وعلى رغم صعوبة نظُم عقديْ ما بعد الاستقلال في الجزائر فقد برز أيضاً شاعر آخر ذو عزف متفرد وصوت متمرد هو بشير حاج علي (1920- 1989)، وقد تميزت إنتاجيته الشعرية بكونها عابرة للغات، وقد فك الحبْسة الشعرية أيضاً باللغة العربية، وأنتج بها إلى جانب كتابته بالفرنسية.
فولتير.. جزائرياً
لقد كان نشدان الحرية وتأكيد الذات والهوية والاستقلال هي الديباجات الأساسية دائماً في الأدب الجزائري، سرداً وشعراً، طيلة فترة حرب التحرير، وحتى قبل ذلك خلال الهبّات الثورية المتكررة ضد الاستعمار الاستيطاني على امتداد الـ132 سنة من الاحتلال الفرنسي. وقد ظهر أصلاً أوائل كتاب السرد المغاربيين بلسان فولتير في الجزائر تحديداً وفي وقت مبكّر نسبياً، مثلاً مع سي امْحمد بن رحال الذي نشر قصة باللغة الفرنسية سنة 1891، في حين لم تظهر الرواية الأولى بلسان فولتير سوى سنة 1920 وهي للكاتب بن سي أحمد بنشريف (1879- 1921)، وكانت بعنوان: «أحمد بن مصطفى، مجند الهجّانة». وضمن هذا الجيل الأول من الكتاب المفرنسين يمكن أيضاً ذكر عبد القادر حاج حمو (1891-1953)، وشكري خوجة (1891-1967)، ومحمد ولد الشيخ (1905- 1938)، وعلي الحمّامي (1902-1949)، ورباح زناتي (1877- 1952)، وجميلة دباش (+1926)، وماري لويز طاووس عمروش (1913- 1976). هذا في حين كان أخوها الإعلامي الشهير جان عمروش (1906- 1962) هو أول من قدم لمدونة الأدب الجزائري والمغاربي الناطق بالفرنسية نصوصاً شعرية عامرة بفضاء روحي ومسكونة بأسئلة البحث عن مقومات الذات والهوية.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945 شهدت الجزائر طفرة نوعية في السرد المكتوب بالفرنسية، وقد استأثرت بنصيب وافر من ذلك خاصة منطقة «القبائل» (اسم يطلق على مناطق «البربر»- الأمازيغ، حيث يسمى أمازيغ ولاية تيزي أوزو في جبال جرجرة بشمال الجزائر «القبائل الكبرى»، فيما يسمى أمازيغ ولاية بجاية بالشرق «القبائل الصغرى»)، حيث ظهر ثلاثة كُتاب كبار دفعة واحدة حملوا معاً هموم أمة صاعدة، وعكسوا معاناة بلد يئن تحت نير المعاناة وجحيم الاحتلال. وهؤلاء الكتاب الثلاثة هم مالك واري، ومولود معمري (1917-1989)، صاحب «الربوة المنسية»، و«سبات الحقيقة»، وخاصة مولود فرعون الذي استبطنت أعماله ثيمات موضوعية كثيرة لعل أبرزها السعي لتأكيد الذات والهوية الوطنية الجزائرية أولاً طيلة فترة حرب التحرير، ثم تجديد وتأكيد الثقافة والهوية البربرية الأمازيغية، تالياً، في مرحلة ما بعد الاستقلال. وفِي الموقف الأول الرافض للاحتواء والانمحاء في الهوية الفرنسية -عندما كانت فرنسا تعتبر الجزائريين فرنسيين مسلمين، والجزائر إقليماً فرنسياً مدمجاً، وليس مجرد مستعمرة- أطلق مولود فرعون مقولته الشهيرة: «إنني أكتب باللغة الفرنسية لكي أقول للفرنسيين بأنني لستُ فرنسياً». ولمولود فرعون أعمال سردية وأدبية كثيرة منها: «أيام قبائلية»، ويستعرض فيه عادات وتقاليد منطقة «القبائل»، وقد طبع سنة 1954. و«أشعار سي محند» وطبع سنة 1960. وروايته الأكثر شهرة «ابن الفقير» وقد كتبها في شهر إبريل سنة 1940. وكذلك من أعماله الأخرى «الذكرى» وطبع سنة 1972. و«الدروب الوعرة» وصدر سنة 1957. و«الأرض والدم» 1953. و«مدينة الورود» 2007. و«رسائل إلى الأصدقاء» 1969.. الخ.
وفي الغرب الجزائري بزغ نجم محمد ديب (1920-2003)، بعوالمه السردية الواقعية المبهرة وشخوصه الذين كان يمتاح ملامحهم من يوميات الشرائح الأكثر شعبية في المدن والأرياف، وقد رسم ذلك الفضاء السردي المبهر في ثلاثيته الروائية «الجزائر»، وهي تشمل روايات «الدار الكبيرة» و«الحريق»، و«النَّوْل». وقد تدثرت نصوصه بإهاب شعري ونفَسٍ غنائي، مع قوة استحضار واستدعاء للإحالات التراثية، ومن هذا الخليط الإبداعي قدم منتجاً أدبياً يتجاوز الحاضر الصعب إلى التبشير بغد آتٍ وأكثر من فجر صادق مقبل في الأفق. وبشكل خاص فقد كانت روايته: «الحريق»، (المنشورة في صيف 1954)، مترعة بفضاء استعاري مجازي يحمل أكثر من نبوءة جديرة بأن تكون محققة لذاتها (فبعد أشهر قليلة من صدور الرواية اندلعت الثورة الجزائرية في 1954 التي انتهت بالتحرير والاستقلال في 1962).
وإضافة إلى الثلاثية فقد كتب محمد ديب أيضاً مدونة سردية منوعة أخرى شملت قصص الأطفال، والقصص القصيرة مثل مجموعة «في المقهى» القصصية 1955، وروايات كثيرة جداً منها «صيف إفريقي» 1959، و«من يتذكر البحر» 1962، و«رقصة الملك» 1968، و«معلم الصيد» 1973، و«سبات حواء» 1989، و«ثلج الرخام» 1990، و«الليلة المتوحشة» 1995، و«إن شاء الشيطان» 1998.. كما أنتج دواوين شعرية عديدة كان آخرها «أشعار» الذي نشر في 2007.
ومن أبرز كتاب السرد الجزائريين أيضاً رشيد ميموني (1945-1995)، ومن أشهر رواياته «الربيع لن يكون إلا أجمل» 1978، وفيه يسرد صوراً من الحب والحياة والموت واليوميات الصعبة خلال فترة اندلاع ثورة التحرير الجزائرية. وقد عكس عمله «النهر الذي حُول مجراه» 1982، بعض أصداء خيبة الأمل في مرحلة ما بعد الاستقلال، وبطلها أحد قدامى المشاركين في الحرب، كان الجميع يظنون أنه قد لقي مصرعه، ولكنه يعود فجأة إلى القرية، ليكتشف أن كثيراً مما كان يتوقع تحقيقه من أحلام وردية لم يرَ النور أبداً، ويصف البطل بمرارة صوراً مختلفة من الفساد، والديماغوجية وعدم مطابقة الأقوال للأفعال. وهذه السردية تذكر بقصة الروائي الجزائري الطاهر وطار «الشهداء يعودون هذا الأسبوع» المكتوبة باللغة العربية.
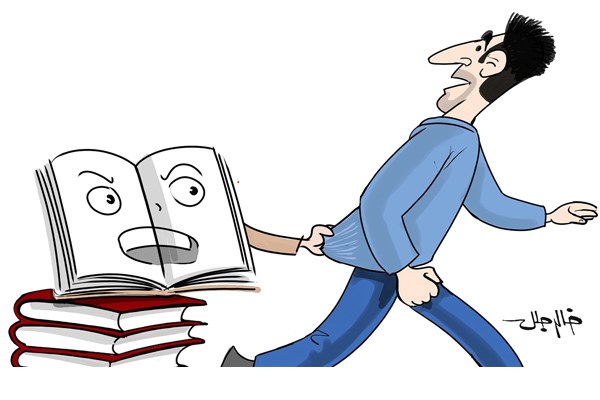
كاتب.. ثورة!
وفِي شرق الجزائر ظهر أيضاً روائيان عظيمان هما مالك حداد (1927-1978)، وكاتب ياسين (1929-1989)، وقد أرسيا تقاليد رسم الفضاء المكاني لعوالم السرد الروائي الجزائري في تلك الفترة. وكانت عوالم روايات كاتب ياسين خاصة طافحة بهواجس البحث عن الزمن الذاهب، وتباريح الهوى والشوق والحب، والأصل والفصل وقلق وألق الأساطير المؤسسة، مشكـِّـلة بذلك بدايات تقاليد كتابة سردية جديدة، حالمة بوطن صاعد من تحت ركام أعباء وفوضى التاريخ. وقد بلغ سرد كاتب ياسين، الذين يعتبره كثيرون «كاتب الثورة» الجزائرية، الذروة مع رواية «نجمة» الصادرة في 1956، والمعتبرة أحد أكبر الأعمال السردية المغاربية المكتوبة بالفرنسية. ولعل لقوة الحبكة والقدرة على المناورة السردية دخلاً في هذا الاحتفاء والاحتفال النقدي الواسع برواية «نجمة». و«يقسّم ياسين روايته إلى عدّة أقسام، وكلّ قسم إلى عدّة فصول متفاوتة الطول. يبدو بعضها مكتوباً بطريقة ممسرحة، حيث الجمل القصيرة المعبرة، والتتابع والتعاقب، وسرعة الانتقال والتبدل، في حين يحضر في بعضها الآخر اشتغال على السرد وتهجينه بالشعر، وبث المناجيَات ذات الدلالات الواقعية والإشارات المنطلقة في أكثر من اتجاه».
وكانت آسيا جبار بمعنى ما، بمثابة آخر العنقود ضمن كتاب الجيل المؤسس، للكتابة الأدبية المفرنسة في الجزائر، وقد دخلت في المشهد الأدبي، ابتداءً، بقوة وعلى نحو صاخب بعملها «العطش» أو «الظمأ»، الذي أثار حينها كثيراً من الجدل، وأسالت ردود الفعل عليه كثيراً من المداد.
ساردات وشاعرات من الجزائر
وعلى ذكر آسيا جبار، لاشك في استحقاق كاتبات السرد -والشعر- الجزائريات الفرانكوفونيات، أن نتحول إليهن قليلاً، وبحكم أسبقيتهن الزمنية، فلا بأس أيضاً بإشارة عامة، دون تفصيل مع شقيقاتهن المغاربيات الأخريات.
لقد سجل تاريخياً ظهور العديد من الكاتبات ذوات الأصول الفرنسية والأجنبية المستوطنات في الدول المغاربية اللواتي نشرن في وقت مبكّر من القرن العشرين أعمالاً أدبية تتخذ من المجال المغاربي فضاء سردياً أو شعرياً. وقد شهدت الجزائر بشكل خاص ظهور العديد من هؤلاء الأديبات المتمغـْـربات خلال الفترة الممتدة من 1919 إلى 1939. بل إن بعضاً من هؤلاء الكاتبات اتخذن أسماء مستعارة عربية مثل «صديق بن العوطة» و«بنت الجبل». كما ظهر منذ العشرينات العديد مِن كاتبات السرد اليهوديات المستوطنات في المنطقة المغاربية، واللواتي هاجرت أغلبيتهن الساحقة في فترة تالية إلى فرنسا وأوروبا.
ومنذ أربعينيات القرن العشرين بدأت الكوكبة الأولى من الساردات المغاربيات في الجزائر والمغرب وتونس، اللواتي اتخذن من الفرنسية سبيلاً لتوصيل رسائلهن، واستمر هذا التيار الأدبي النسوي الناطق بالفرنسية يزداد حضوراً وزخماً منذ تلك الأيام وحتى الآن. وقد ظهرت منذ ذلك التاريخ أعداد كبيرة من الروائيات والقاصات والناقدات والكاتبات المتمرسات ذوات الصفة. وكما حملت المرأة المغاربية البندقية خلال فترة النضال من أجل الاستقلال، حملت فيما بعد الريشة والقلم للتصدي للشأن العام، والتعبير عن تطلعاتها وتطلعات مجتمعها.
وثمة أجيال من المبدعات الجزائريات اللواتي كتبن بالفرنسية، يمكن أن نسوق هنا جانباً من المدونة السردية والشعرية التي أنتجنها، وسنسوق نماذج منهن هنا، إجرائياً، بحسب تصنيف كلاسيكي بسيط يركز على لفت الانتباه على موضوعات الاستظهار المطروقة في الأساس.
وقد كان من اللافت لجوء كثير منهن للنشر بأسماء مستعارة (ومن ذلك مثلاً أن الأديبة الراحلة وعضو الأكاديمية الفرنسية آسيا جبار كان اسمها الأصلي عند الولادة هو فاطمة الزهراء إملهاين! بل إن ظاهرة استخدام الأسماء المستعارة امتدت حتى إلى الرجال لدواعٍ مختلفة، وعلى سبيل المثال فالروائي الشهير ياسمينا خضرا اسمه الحقيقي محمد مولسهول، وقد اتخذ هذا الاسم النسائي المستعار المكوّن من لقبي زوجته حتى لا ينشر باسمه الحقيقي لدواع تتعلق بواجب التحفظ المهني لكونه ضابطاً في الجيش الجزائري). واستخدام الكاتبات خاصة للأسماء المستعارة أمر مفهوم لجهة دلالته على السعي للتخفف من عبء المسؤولية أمام أية إساءات فهم محتملة، أو محاكمة نوايا، أو مماثلة بين الشخص الكاتب والشخوص في أعماله، وأيضاً للنأي باسم العائلة أو الزوج عن أية إسقاطات غير ملائمة للعام على الخاص، أو للنص على الناص، إن صح هذا التعبير الأخير. تماماً مثلما أن من الظواهر الأسلوبية اللافتة أيضاً في السرد النسوي الجزائري قلة استخدام ضمير المتكلم، وهو ما قد يعضد ويسند هذا النزوع نفسه لأخذ مسافة أمان من النص توجساً مما قد يستوْلده من ضغط اجتماعي.
أما من حيث الموضوعات فتغلب على السرديات النسوية الجزائرية، الموضوعات الاجتماعية، وإن كانت القضية الوطنية ظلت أيضاً موضوع استظهار أساسياً طيلة فترة حرب التحرير، وفي السنوات اللاحقة على الاستقلال. ولكن مع كرّ مسبحة الزمن زاد تنوع موضوعات الرواية النسوية الجزائرية، ففي قضايا المرأة مثلاً كان من أبرز الأعمال السردية رواية «ليلى، بنت جزائرية» لجميلة دبيش 1947، ثم روايتها الأخرى «عزيزة» 1955، وكذلك أعمال آسيا جبار «العطش» 1957، و«نافدو الصبر» 1958، و«أطفال العالم الجديد» 1962، و«القبّرات الساذجة» 1967. وكذلك رواية «الشرنقة» لعائشة لمسين 1976، و«الكاو بوي» لجميلة لشمت، و«الربيع اليائس» لفائزة تواتي 1984، و«صابرينا، لقد سرقوا منك الحياة» 1986 وهي رواية لمريم بن -اسم مستعار- وكذلك تطغى هموم ومعاناة المرأة في رواية «فاطمة، أو الجزائريات في الميدان» لليلى صبار 1981، التي كان الهم النسوي مركزياً ويكاد يختصر مدونتها السردية كلها، حيث أصدرت أيضاً أعمالاً روائية أخرى عديدة عن قضايا بنات جنسها من أشهرها روايات «شهرزاد» 1982، و«دفاتر شهرزاد» 1985، و«تحدّث يا بني، تحدّث لأمك» 1984، و«الصيني الأخضر الأفريقي» 1984. وكذلك تتنزل في هذا السياق الموضوعي الاجتماعي رواية حفصة زيناي- كوديل «الرهان الخاسر» 1986، وهذه الكاتبة اشتهرت لها بشكل خاص روايتاها «نهاية حلم» 1984، و«الفراشة لن تطير» 1990.
وفِي تركيز السرد النسوي الجزائري على الموضوعات الاجتماعية تطغى مشكلات العلاقات الأسرية والزوجية، وحالات الحب المغدورة، وتعقيد العلاقات في المجتمع التقليدي. وفِي مرحلة زمنية تالية ظهرت في عوالم هذا السرد أيضاً مشكلات الشباب الجزائري في فرنسا والفرنسي من أصل جزائري، وخاصة من الجيل الثاني من أبناء المهاجرين الأول.


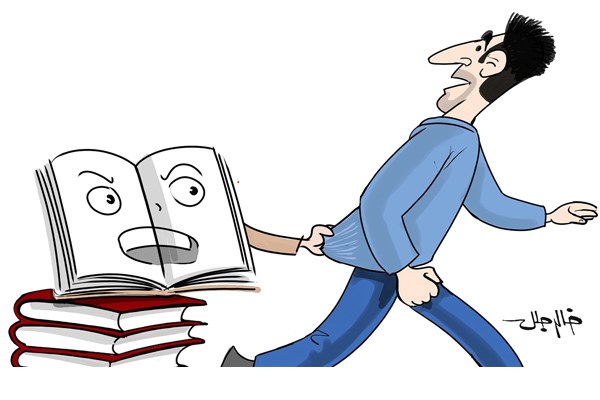 كاتب.. ثورة!
وفِي شرق الجزائر ظهر أيضاً روائيان عظيمان هما مالك حداد (1927-1978)، وكاتب ياسين (1929-1989)، وقد أرسيا تقاليد رسم الفضاء المكاني لعوالم السرد الروائي الجزائري في تلك الفترة. وكانت عوالم روايات كاتب ياسين خاصة طافحة بهواجس البحث عن الزمن الذاهب، وتباريح الهوى والشوق والحب، والأصل والفصل وقلق وألق الأساطير المؤسسة، مشكـِّـلة بذلك بدايات تقاليد كتابة سردية جديدة، حالمة بوطن صاعد من تحت ركام أعباء وفوضى التاريخ. وقد بلغ سرد كاتب ياسين، الذين يعتبره كثيرون «كاتب الثورة» الجزائرية، الذروة مع رواية «نجمة» الصادرة في 1956، والمعتبرة أحد أكبر الأعمال السردية المغاربية المكتوبة بالفرنسية. ولعل لقوة الحبكة والقدرة على المناورة السردية دخلاً في هذا الاحتفاء والاحتفال النقدي الواسع برواية «نجمة». و«يقسّم ياسين روايته إلى عدّة أقسام، وكلّ قسم إلى عدّة فصول متفاوتة الطول. يبدو بعضها مكتوباً بطريقة ممسرحة، حيث الجمل القصيرة المعبرة، والتتابع والتعاقب، وسرعة الانتقال والتبدل، في حين يحضر في بعضها الآخر اشتغال على السرد وتهجينه بالشعر، وبث المناجيَات ذات الدلالات الواقعية والإشارات المنطلقة في أكثر من اتجاه».
وكانت آسيا جبار بمعنى ما، بمثابة آخر العنقود ضمن كتاب الجيل المؤسس، للكتابة الأدبية المفرنسة في الجزائر، وقد دخلت في المشهد الأدبي، ابتداءً، بقوة وعلى نحو صاخب بعملها «العطش» أو «الظمأ»، الذي أثار حينها كثيراً من الجدل، وأسالت ردود الفعل عليه كثيراً من المداد.
ساردات وشاعرات من الجزائر
وعلى ذكر آسيا جبار، لاشك في استحقاق كاتبات السرد -والشعر- الجزائريات الفرانكوفونيات، أن نتحول إليهن قليلاً، وبحكم أسبقيتهن الزمنية، فلا بأس أيضاً بإشارة عامة، دون تفصيل مع شقيقاتهن المغاربيات الأخريات.
لقد سجل تاريخياً ظهور العديد من الكاتبات ذوات الأصول الفرنسية والأجنبية المستوطنات في الدول المغاربية اللواتي نشرن في وقت مبكّر من القرن العشرين أعمالاً أدبية تتخذ من المجال المغاربي فضاء سردياً أو شعرياً. وقد شهدت الجزائر بشكل خاص ظهور العديد من هؤلاء الأديبات المتمغـْـربات خلال الفترة الممتدة من 1919 إلى 1939. بل إن بعضاً من هؤلاء الكاتبات اتخذن أسماء مستعارة عربية مثل «صديق بن العوطة» و«بنت الجبل». كما ظهر منذ العشرينات العديد مِن كاتبات السرد اليهوديات المستوطنات في المنطقة المغاربية، واللواتي هاجرت أغلبيتهن الساحقة في فترة تالية إلى فرنسا وأوروبا.
ومنذ أربعينيات القرن العشرين بدأت الكوكبة الأولى من الساردات المغاربيات في الجزائر والمغرب وتونس، اللواتي اتخذن من الفرنسية سبيلاً لتوصيل رسائلهن، واستمر هذا التيار الأدبي النسوي الناطق بالفرنسية يزداد حضوراً وزخماً منذ تلك الأيام وحتى الآن. وقد ظهرت منذ ذلك التاريخ أعداد كبيرة من الروائيات والقاصات والناقدات والكاتبات المتمرسات ذوات الصفة. وكما حملت المرأة المغاربية البندقية خلال فترة النضال من أجل الاستقلال، حملت فيما بعد الريشة والقلم للتصدي للشأن العام، والتعبير عن تطلعاتها وتطلعات مجتمعها.
وثمة أجيال من المبدعات الجزائريات اللواتي كتبن بالفرنسية، يمكن أن نسوق هنا جانباً من المدونة السردية والشعرية التي أنتجنها، وسنسوق نماذج منهن هنا، إجرائياً، بحسب تصنيف كلاسيكي بسيط يركز على لفت الانتباه على موضوعات الاستظهار المطروقة في الأساس.
وقد كان من اللافت لجوء كثير منهن للنشر بأسماء مستعارة (ومن ذلك مثلاً أن الأديبة الراحلة وعضو الأكاديمية الفرنسية آسيا جبار كان اسمها الأصلي عند الولادة هو فاطمة الزهراء إملهاين! بل إن ظاهرة استخدام الأسماء المستعارة امتدت حتى إلى الرجال لدواعٍ مختلفة، وعلى سبيل المثال فالروائي الشهير ياسمينا خضرا اسمه الحقيقي محمد مولسهول، وقد اتخذ هذا الاسم النسائي المستعار المكوّن من لقبي زوجته حتى لا ينشر باسمه الحقيقي لدواع تتعلق بواجب التحفظ المهني لكونه ضابطاً في الجيش الجزائري). واستخدام الكاتبات خاصة للأسماء المستعارة أمر مفهوم لجهة دلالته على السعي للتخفف من عبء المسؤولية أمام أية إساءات فهم محتملة، أو محاكمة نوايا، أو مماثلة بين الشخص الكاتب والشخوص في أعماله، وأيضاً للنأي باسم العائلة أو الزوج عن أية إسقاطات غير ملائمة للعام على الخاص، أو للنص على الناص، إن صح هذا التعبير الأخير. تماماً مثلما أن من الظواهر الأسلوبية اللافتة أيضاً في السرد النسوي الجزائري قلة استخدام ضمير المتكلم، وهو ما قد يعضد ويسند هذا النزوع نفسه لأخذ مسافة أمان من النص توجساً مما قد يستوْلده من ضغط اجتماعي.
أما من حيث الموضوعات فتغلب على السرديات النسوية الجزائرية، الموضوعات الاجتماعية، وإن كانت القضية الوطنية ظلت أيضاً موضوع استظهار أساسياً طيلة فترة حرب التحرير، وفي السنوات اللاحقة على الاستقلال. ولكن مع كرّ مسبحة الزمن زاد تنوع موضوعات الرواية النسوية الجزائرية، ففي قضايا المرأة مثلاً كان من أبرز الأعمال السردية رواية «ليلى، بنت جزائرية» لجميلة دبيش 1947، ثم روايتها الأخرى «عزيزة» 1955، وكذلك أعمال آسيا جبار «العطش» 1957، و«نافدو الصبر» 1958، و«أطفال العالم الجديد» 1962، و«القبّرات الساذجة» 1967. وكذلك رواية «الشرنقة» لعائشة لمسين 1976، و«الكاو بوي» لجميلة لشمت، و«الربيع اليائس» لفائزة تواتي 1984، و«صابرينا، لقد سرقوا منك الحياة» 1986 وهي رواية لمريم بن -اسم مستعار- وكذلك تطغى هموم ومعاناة المرأة في رواية «فاطمة، أو الجزائريات في الميدان» لليلى صبار 1981، التي كان الهم النسوي مركزياً ويكاد يختصر مدونتها السردية كلها، حيث أصدرت أيضاً أعمالاً روائية أخرى عديدة عن قضايا بنات جنسها من أشهرها روايات «شهرزاد» 1982، و«دفاتر شهرزاد» 1985، و«تحدّث يا بني، تحدّث لأمك» 1984، و«الصيني الأخضر الأفريقي» 1984. وكذلك تتنزل في هذا السياق الموضوعي الاجتماعي رواية حفصة زيناي- كوديل «الرهان الخاسر» 1986، وهذه الكاتبة اشتهرت لها بشكل خاص روايتاها «نهاية حلم» 1984، و«الفراشة لن تطير» 1990.
وفِي تركيز السرد النسوي الجزائري على الموضوعات الاجتماعية تطغى مشكلات العلاقات الأسرية والزوجية، وحالات الحب المغدورة، وتعقيد العلاقات في المجتمع التقليدي. وفِي مرحلة زمنية تالية ظهرت في عوالم هذا السرد أيضاً مشكلات الشباب الجزائري في فرنسا والفرنسي من أصل جزائري، وخاصة من الجيل الثاني من أبناء المهاجرين الأول.
كاتب.. ثورة!
وفِي شرق الجزائر ظهر أيضاً روائيان عظيمان هما مالك حداد (1927-1978)، وكاتب ياسين (1929-1989)، وقد أرسيا تقاليد رسم الفضاء المكاني لعوالم السرد الروائي الجزائري في تلك الفترة. وكانت عوالم روايات كاتب ياسين خاصة طافحة بهواجس البحث عن الزمن الذاهب، وتباريح الهوى والشوق والحب، والأصل والفصل وقلق وألق الأساطير المؤسسة، مشكـِّـلة بذلك بدايات تقاليد كتابة سردية جديدة، حالمة بوطن صاعد من تحت ركام أعباء وفوضى التاريخ. وقد بلغ سرد كاتب ياسين، الذين يعتبره كثيرون «كاتب الثورة» الجزائرية، الذروة مع رواية «نجمة» الصادرة في 1956، والمعتبرة أحد أكبر الأعمال السردية المغاربية المكتوبة بالفرنسية. ولعل لقوة الحبكة والقدرة على المناورة السردية دخلاً في هذا الاحتفاء والاحتفال النقدي الواسع برواية «نجمة». و«يقسّم ياسين روايته إلى عدّة أقسام، وكلّ قسم إلى عدّة فصول متفاوتة الطول. يبدو بعضها مكتوباً بطريقة ممسرحة، حيث الجمل القصيرة المعبرة، والتتابع والتعاقب، وسرعة الانتقال والتبدل، في حين يحضر في بعضها الآخر اشتغال على السرد وتهجينه بالشعر، وبث المناجيَات ذات الدلالات الواقعية والإشارات المنطلقة في أكثر من اتجاه».
وكانت آسيا جبار بمعنى ما، بمثابة آخر العنقود ضمن كتاب الجيل المؤسس، للكتابة الأدبية المفرنسة في الجزائر، وقد دخلت في المشهد الأدبي، ابتداءً، بقوة وعلى نحو صاخب بعملها «العطش» أو «الظمأ»، الذي أثار حينها كثيراً من الجدل، وأسالت ردود الفعل عليه كثيراً من المداد.
ساردات وشاعرات من الجزائر
وعلى ذكر آسيا جبار، لاشك في استحقاق كاتبات السرد -والشعر- الجزائريات الفرانكوفونيات، أن نتحول إليهن قليلاً، وبحكم أسبقيتهن الزمنية، فلا بأس أيضاً بإشارة عامة، دون تفصيل مع شقيقاتهن المغاربيات الأخريات.
لقد سجل تاريخياً ظهور العديد من الكاتبات ذوات الأصول الفرنسية والأجنبية المستوطنات في الدول المغاربية اللواتي نشرن في وقت مبكّر من القرن العشرين أعمالاً أدبية تتخذ من المجال المغاربي فضاء سردياً أو شعرياً. وقد شهدت الجزائر بشكل خاص ظهور العديد من هؤلاء الأديبات المتمغـْـربات خلال الفترة الممتدة من 1919 إلى 1939. بل إن بعضاً من هؤلاء الكاتبات اتخذن أسماء مستعارة عربية مثل «صديق بن العوطة» و«بنت الجبل». كما ظهر منذ العشرينات العديد مِن كاتبات السرد اليهوديات المستوطنات في المنطقة المغاربية، واللواتي هاجرت أغلبيتهن الساحقة في فترة تالية إلى فرنسا وأوروبا.
ومنذ أربعينيات القرن العشرين بدأت الكوكبة الأولى من الساردات المغاربيات في الجزائر والمغرب وتونس، اللواتي اتخذن من الفرنسية سبيلاً لتوصيل رسائلهن، واستمر هذا التيار الأدبي النسوي الناطق بالفرنسية يزداد حضوراً وزخماً منذ تلك الأيام وحتى الآن. وقد ظهرت منذ ذلك التاريخ أعداد كبيرة من الروائيات والقاصات والناقدات والكاتبات المتمرسات ذوات الصفة. وكما حملت المرأة المغاربية البندقية خلال فترة النضال من أجل الاستقلال، حملت فيما بعد الريشة والقلم للتصدي للشأن العام، والتعبير عن تطلعاتها وتطلعات مجتمعها.
وثمة أجيال من المبدعات الجزائريات اللواتي كتبن بالفرنسية، يمكن أن نسوق هنا جانباً من المدونة السردية والشعرية التي أنتجنها، وسنسوق نماذج منهن هنا، إجرائياً، بحسب تصنيف كلاسيكي بسيط يركز على لفت الانتباه على موضوعات الاستظهار المطروقة في الأساس.
وقد كان من اللافت لجوء كثير منهن للنشر بأسماء مستعارة (ومن ذلك مثلاً أن الأديبة الراحلة وعضو الأكاديمية الفرنسية آسيا جبار كان اسمها الأصلي عند الولادة هو فاطمة الزهراء إملهاين! بل إن ظاهرة استخدام الأسماء المستعارة امتدت حتى إلى الرجال لدواعٍ مختلفة، وعلى سبيل المثال فالروائي الشهير ياسمينا خضرا اسمه الحقيقي محمد مولسهول، وقد اتخذ هذا الاسم النسائي المستعار المكوّن من لقبي زوجته حتى لا ينشر باسمه الحقيقي لدواع تتعلق بواجب التحفظ المهني لكونه ضابطاً في الجيش الجزائري). واستخدام الكاتبات خاصة للأسماء المستعارة أمر مفهوم لجهة دلالته على السعي للتخفف من عبء المسؤولية أمام أية إساءات فهم محتملة، أو محاكمة نوايا، أو مماثلة بين الشخص الكاتب والشخوص في أعماله، وأيضاً للنأي باسم العائلة أو الزوج عن أية إسقاطات غير ملائمة للعام على الخاص، أو للنص على الناص، إن صح هذا التعبير الأخير. تماماً مثلما أن من الظواهر الأسلوبية اللافتة أيضاً في السرد النسوي الجزائري قلة استخدام ضمير المتكلم، وهو ما قد يعضد ويسند هذا النزوع نفسه لأخذ مسافة أمان من النص توجساً مما قد يستوْلده من ضغط اجتماعي.
أما من حيث الموضوعات فتغلب على السرديات النسوية الجزائرية، الموضوعات الاجتماعية، وإن كانت القضية الوطنية ظلت أيضاً موضوع استظهار أساسياً طيلة فترة حرب التحرير، وفي السنوات اللاحقة على الاستقلال. ولكن مع كرّ مسبحة الزمن زاد تنوع موضوعات الرواية النسوية الجزائرية، ففي قضايا المرأة مثلاً كان من أبرز الأعمال السردية رواية «ليلى، بنت جزائرية» لجميلة دبيش 1947، ثم روايتها الأخرى «عزيزة» 1955، وكذلك أعمال آسيا جبار «العطش» 1957، و«نافدو الصبر» 1958، و«أطفال العالم الجديد» 1962، و«القبّرات الساذجة» 1967. وكذلك رواية «الشرنقة» لعائشة لمسين 1976، و«الكاو بوي» لجميلة لشمت، و«الربيع اليائس» لفائزة تواتي 1984، و«صابرينا، لقد سرقوا منك الحياة» 1986 وهي رواية لمريم بن -اسم مستعار- وكذلك تطغى هموم ومعاناة المرأة في رواية «فاطمة، أو الجزائريات في الميدان» لليلى صبار 1981، التي كان الهم النسوي مركزياً ويكاد يختصر مدونتها السردية كلها، حيث أصدرت أيضاً أعمالاً روائية أخرى عديدة عن قضايا بنات جنسها من أشهرها روايات «شهرزاد» 1982، و«دفاتر شهرزاد» 1985، و«تحدّث يا بني، تحدّث لأمك» 1984، و«الصيني الأخضر الأفريقي» 1984. وكذلك تتنزل في هذا السياق الموضوعي الاجتماعي رواية حفصة زيناي- كوديل «الرهان الخاسر» 1986، وهذه الكاتبة اشتهرت لها بشكل خاص روايتاها «نهاية حلم» 1984، و«الفراشة لن تطير» 1990.
وفِي تركيز السرد النسوي الجزائري على الموضوعات الاجتماعية تطغى مشكلات العلاقات الأسرية والزوجية، وحالات الحب المغدورة، وتعقيد العلاقات في المجتمع التقليدي. وفِي مرحلة زمنية تالية ظهرت في عوالم هذا السرد أيضاً مشكلات الشباب الجزائري في فرنسا والفرنسي من أصل جزائري، وخاصة من الجيل الثاني من أبناء المهاجرين الأول.
